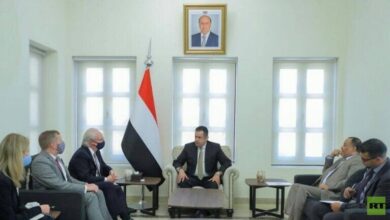هل يمر طريق إحتراف “إسبرطة” من اليمن؟

حيروت – خاص
لم يعد سراً ذلك التوجه الإماراتي الذي مضى نحو بناء واستثمار القدرات الأمنية والعسكرية، فخلال عقدين متواصلين من الزمن، سعت دولة الإمارات التي أُطلق عليها “إسبرطة صغيرة” للتعويض عن حجمها المتواضع وتاريخها السياسي حديث العهد، من خلال إيجاد موقع عسكري موازٍ أو على الأقل منافس للقوى الإقليمية المتواجدة، مسخّرةً لأجل ذلك طرق مشروعة وغير مشروعة، مثل ثرواتها الطبيعية، وتقديم تنازلات سياسية ودبلوماسية كثيرة وكبيرة، آخررها التطبيع مع إسرائيل. كما استغلت العديد من الظروف في المنطقة، أبرزها هشاشة بعض الدول العربية مثل الصومال وسوريا وليبيا واليمن، لتنفيذ اختراقات أمنية وعمليات عسكرية فيها، وصولاً إلى تأسيس ودعم ما يُعرف بالوكلاء المحليين، ومن ثم استحداث موطئ قدم لها في الدول الهشة ما يهيئ لها الطريق عبر العدوان عليها لتحقيق طموحها نحو الصعود الإقليمي؛ فهل يمثل اليمن بيئة خصبة لإرضاء غرور وطموح “إسبرطة”؟
تؤكد العديد من التقارير والدراسات الدولية بأن الإمارات استغلت عدوانها على اليمن لتنفيذ العديد من المصالح وجني الكثير من المكتسبات، وقد أختلفت التقارير في ترتيب أولويات “إسبرطة” في هذا البلد، لكنها اتفقت جميعهاعلى أن الإمارات استغلت اليمن كبيئة مناسبة لتطوير احترافها الأمني والعسكري وكسب العديد من الخبرات، إذ ذكرت دراسة لمركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، بعنوان: “تطوّر التعاون العسكري والأمني الخارجي الإماراتي: الطريق نحو الاحتراف العسكري”، بأنه “بعد خمس سنوات من القتال في اليمن، اكتسبت الإمارات خبرة في العمل في البيئات الحضرية والبرمائية، وإجراء عمليات معقدة تنطوي على قدرات جوية وبرية وبحرية، وقد كسبت ذلك رغم تكبدها أكبر خسائرها العسكرية، سيّما في عام 2015، عندما قُتل 45 جندياً إماراتياً في ضربة صاروخية واحدة”.
ورأت الدراسة أن “الإمارات ستحتاج إلى الاستثمارات في المؤسسات للدروس الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية المستفادة وحلقات التغذية الراجعة للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للقوات مباشرةً من حرب اليمن، حيث الدروس لا تزال حديثة”.
لقد سخّرت الإمارات في عدوانها على اليمن العديد من الوسائل لتنفيذ أجندتها، ففي عام 2015، ذكرت تقارير بأنها نشرت 450 جندياً من المرتزقة من أمريكا اللاتينية، معظمهم من كولومبيا، ومن تشيلي والسلفادور وبنما، لتعزيز الحرب بالوكالة في اليمن.
ودفع اليمن ولا يزال يدفع ثمن هذا الهوس والغطرسة الإماراتية، حيث وثّق مكتب المفوّض السامي للأمم المتحدة انتهاكات وجرائم من قبل الإمارات والميليشيا المسلحة المدعومة منها. كما أدانت المنظمات الإنسانية وجماعات المناصرة الأعتداءات الإماراتية على اليمن، مثل استخدام القوة المتوحشة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وإنشاء سجون تعذيب سرية في اليمن.
وليس اليمن البلد الوحيد الذي اتخذت منه الإمارات حقل تجارب للسعي نحو تطوير احترافها على حساب أمن واستقرار شعبه، فقد سبق وأن شاركت بتنفيذ عمليات في الصومال عام 1992، كما شاركت مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو وأفغانستان، وإلى جانب القوات السعودية لقمع الانتفاضة في البحرين خلال احتجاجات الربيع العربي، إلا أنها، وبالرغم مما تدعيه من خبرة عملياتية واسعة “لم تخطط أو تنفذ حملة عسكرية واحدة بمفردها، حتى مشاركتها في الحرب في اليمن” جاءت بمساعدة أجنبية مدفوعة الثمن، بحسب ما تشير إليه الدراسة ذاتها.
ربما أن الإمارات تقدمت خطوة نحو بناء قدراتها وراكمت من خبراتها الأمنية والعسكرية كأي دولة نهمة بالأستحواذ والسيطرة من خلال العدوان على الدول والشعوب المستقلة، لكن أغلب وسائلها وقتية ومُعلّبة، غير مبنية على أسس ومعايير قيمية استراتيجية، سواء من حيث استخدامها للمرتزقة الأجانب وتعاقدها مع الشركات الأمنية مثل (بلاك ووتر)، أو من حيث اعتمادها على الوكلاء المحليين، كالمجلس الإنتقالي الجنوبي والقوات المشتركة والنخبة والعمالقة وغيرها، والأهم من ذلك اعتمادها الرئيسي على الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة وفرنسا واستراليا. حيث ترى الدراسة المذكورة، أن “على الإمارات إجراء مراجعة ملموسة لتدخلاتها في اليمن، والتي اختبرت خلالها هيكل قوتها وقدراتها العسكرية، إذ أن أبوظبي استأجرت وحشدت مجموعات المرتزقة والوكلاء لاستكمال قواتها، ما فاقم الفجوات في قدراتها على التخطيط الاستراتيجي”.
وتبقى مسألة احتراف القوات الإماراتية من عدمها قائمة على القيم التي تقوم عليها القوات المسلحة الإماراتية كمؤسسة، بما في ذلك ما إذا كانت تدعم الصراع المسلح واعتمادها على قوات المرتزقة، إذ تشير المخاوف الدولية إلى قيود على نموها كقوة عسكرية محترفة وقد تحد من التعاون الدولي معها مع مرور الوقت، وقد أدت مثل هذه المخاوف إلى تدقيق الكونجرس الأمريكي، حيث لاتزال تفتقر مؤسستها العسكرية على تدابير الرقابة والمساءلة والشفافية لضمان الالتزام بقانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، بحسب ما تناولته دراسة (كارنيغي).