عدن بين الأسطورة والواقع.. هوامش على حوار الأصول والفصول! بقلم| امين اليافعي
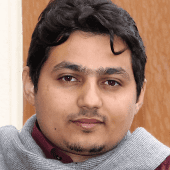
بقلم| امين اليافعي
أن تتحول “هبالات ليلى ربيع” إلى مواضيع رأي عامة، ينخرط فيها الجميع من أبسط ناشط إلى أكبر مثقف، فهذه باتت من الأمور التي لا غرابة فيها، وباتت توفر فرص سانحة وحيوية للهروب من عمق القضايا والتحولات الجوهرية إلى سطحها، حيث يكتفي الجميع بالتنديد.
ما وراء الحوار القصير الذي جرى بين الشاب العدني وليلى ربيع تقف الكثير من التصنيفات والأسئلة والصراعات والمصالح والأحلام والواقع والأساطير.
وفي هذا الصدد، لا أتذكر أنني تبادلتُ حديثاً مع أحد اليمنيين – قبل سابق معرفة – دون أن يطرح عليّ سؤال مباشراً: “من أين أنت؟”، وبعد مضي أقل من دقيقتين على بدء المحادثة. وإن امتد زمن المحادثة لأكثر من خمس دقائق، سيكرر عليّ بعد معرفته للمنطقة التي أنتمي إليها، وفي الغالب سيُكرر لأكثر من مرة، إندهاشه الشديد – الذي يُفترض ببي أن أفهمه / أتقبله كإطراء – عن الاختلاف الكبير بين الصورة النمطية المنطبعة في ذهنه عن المنتمين إلى هذه المنطقة وبين الشخصية التي تقف أمامه. وبين القدح الجماعي والمدح الشخصي يُفترض بي أن أتقبّل الأمر دون تحسس، أو دون الكثير منه، حتى تمضي الأمور بهدوء وسلام.
المشهد الذي جرى بين الشاب وليلى ربيع، ويبدو كمشهد تمثيلي مأخوذ من أحد الأفلام، يستدعي قراءة أوسع وأعمق لكل العوامل المحركة والخيوط المرتبطة بهذا الاحتدام المتصاعد.
ربما ستكون البداية من نقطة أساسية، وهي: هل مدينة عدن كانت بالفعل، وعلى الدوام، مدينة لا تسأل أحداً عن أصوله عند وصوله إليها، وإقامته بها؟
الإجابة الشائعة هي أقرب إلى الأسطرة أو التمني منها إلى الحقيقة. كان السؤال عن الأصول، والامتيازات التي تُمنح بناء على الأصول، أحد اهم السمات التي ظلت سائدة ومتفشية في التاريخ المعاصر لمدينة عدن. الاختلاف الوحيد هو الموقف من صاحب الانتماء؛ هل هو من “النحن” أم بات من “الهم”، والنحن والهم تتغير باستمرار، وبلمح البصر، تبعاً للصراعات السياسية وأجندتها، والمصالح الاقتصادية، والتأطيرات الثقافية…إلخ.
في الفترة الأوسع من عمر الاستعمار البريطاني، أي ما يُقارب الـ٩٠٪ من هذه الفترة، كان العربي: العدني، الجنوبي، اليمني، حسب تصنيفات وهويات تلك الفترة، هو الحلقة الأضعف في عدن. مرات كثيرة كتب رائد التنوير محمد علي لقمان عن معاناة العدني في وطنه: “إنها لا توجد بلاد من بلدان العالم المتحضر يتنمر الأجنبي فيها على الوطني إلا في عدن، عدن بلاد المتناقضات، بلاد الأجنبي فيها عزيز والمواطن فيها ذليل” (فتاة الجزيرة، السنة الأولى ١٩٤٠ من كتاب: فتاة الجزيرة افتتاحيات ومقالات ١٩٤٠ – ١٩٥٠، المكتبة العصرية، بيروت، ص ٦٤٩ – ٦٥١). “أننا محرومون من الوظائف السمينة والمراتب العالية. نراها رغم أنوفنا تُعطى لغيرنا ونحن نتضور جوعاً فما خوفنا من البطالة؟ إن الأجانب يتمتعون بكل نعيم في عقر دارنا. ونحن لم نزل في نظر الحاكم – غير راشدين” (فتاة الجزيرة افتتاحيات ومقالات ١٩٤٠ – ١٩٥٠، المكتبة العصرية، بيروت، ص ٥٩١)… والكثير الكثير.
في الفترة التي أعقبت استقلال الهند، وتحول عدن من تحت إدارة شركة الهند الشرقية وربطها بالتاج البريطاني مباشرة، تحصل أبناء عدن على بعض الحقوق والامتيازات، لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب، وكما تُشير كثير من الكتابات التي وثقّت لتلك الفترة.
حاول البعض في الفترة السابقة، وتحت ضغط الصراعات السياسية، تحويل هذه الفترة إلى “فردوس للتعايش وتقبّل الآخر”، كرواية “بخور عدني”، لكن النظر إلى عدن من زاوية ماما، العدنية ذات الأصول الصومالية، وميشيل أو فرانسوا الأعرج الفرنسي الهارب من جحيم أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وكما فعلت الرواية، فيه الكثير من التبسيط والإخفاء للتصنيفات والتمايزات والاستبعاد والاقصاء الصريح والضمني المُمارس داخل حدود العلاقات الاجتماعية ونقاط تماسها خصوصا فيما يتعلق بالامتيازات والفرص الكبيرة وكما أشار لقمان وآخرون كُثر، وكذلك طريقة التعامل المختلفة مع نوعية الوافدين (بالنسبة للقادمين من المناطق القريبة من عدن، كان يتم التعامل معهم في منتهى الإهانة عند نقاط التفتيش).
لكن عملية أسطرة المدينة، كانت وما زالت قائمة، وإن كانت هذه الأسطرة مفيدة كحلم أو في سبيل تأسيس نموذج ولو مُتخيّل يتوق الناس إليه في سياق صعب المراس ويبدو غير قابل لتجاوز تصنيفاته التقليدية، لكن على الواقع، وفيما يخص الدور الذي تلعبه الانتماءات والامتيازات التي تُمنح على ضوءها، ظل الحال كما هو دون تغيير، خصوصاً على المستوى الرسمي، عدا عن بعض الجوانب المتعلقة بالقوانين والضوابط.
في فترة ما بعد دولة الاستقلال في الجنوب، تحولت المدينة إلى وطن عزيز ودافئ لليساريين، لكل يساري الشمال والجنوب، والعالم العربي والعالم. في بداية الأمر، لم يلعب الانتماء المذهبي/المكاني/العشائري أي دور طالما قد انضممت إلى الحضرة اليسارية. وعلى أساسه، تجاور الناس من كل مكان، وكان “الأصل المعروف” لدى الجيران لا يُشكِّل فرقاً طالما قد خلى من شبه البرجوازية، ثم بدأ الفرز على أساس الأصول في فترة اشتداد الصراع السلطوي بين الرفاق. على أن القوى التي تم عدّها كـ”قوى تقليدية”، ومعظمها من المحميات الجنوبية وعدن، تم تصنيفها وحشرها في زاوية ضيقة خلال تلك الفترة، والكثير منها تم إرسالها إلى “جحيم” الاشتراكية.
بعد ١٩٩٤، لعب النظام الحاكم بكل الأوراق في سبيل التشكيك في انتماء عدن إلى الفضاء الجنوبي تحت إغراء أنه يعمل على سلب “المشروع الجنوبي” الامتياز بأن تكون عاصمته. وفي هذه الفترة ظهر الترويج لفكرتين / دعوتين متوازيتين: “من هو العدني الأصل؟” “ومن هم أكثر سكان عدن؟”. ومع إن الفكرة الثانية تنقض الأولى تماماً، إذ لا معنى للأصل هنا، ومع ذلك أريد لهما أن يؤديا نفس الدور، وعلى أساسهما ظهر الكثير من الفرز في الإعلام والواقع. في مقابل ذلك ظهرت دعوة مقابلة / ردة فعل من قِبل المتطرفين في الحراك، وهم كثر جدا، لنقض فكرة “العدني الأصل” في سياق الصراع للسيطرة على عدن وإثباتها كعاصمة أبدية ونقية للجنوب. في ظل هذا الصراع المتلاعب به، وبخطورة بالغة، تكون فئة واسعة من العدنيين وقوداً لناره، فضلاً عن تهديم مشروع عدن كمدينة كوزموبوليتية وكفضاء تعايش مدني قابل لنمو، وركيزة لا غنى عنها في بناء دولة حديثة.
وبالعودة إلى الحوار السريع بين الشاب وليلى ربيع، تنعكس في خلفيته كل هذه الاضطرابات والتدافعات والصراعات. يحاول الشاب الاحتماء بالهوية العدنية (الخالصة) تحت إلحاح أن تكريس فكرة “العدني الأصل” توفر له نوع من الحماية والمشروعية، وخوفاً من أي يجري تجريده من أي امتيازات أو حقوق مشروعة أو متوهمة في حال أعلن عن جذوره، مع إنه يعلم أن السؤال هذا طبيعي جداً في بلد كاليمن، فضل عن عدم صمود فكرة “الأصل”. بينما تسقط المذيعة وبخفة وحماقة، وتُمارس الابتزاز لاجبار الشاب على إعلان “أصوله” حتى يتضح لمتابعيها (الشعبويين) سبب عدم تفاعله مع سؤالها الافتتاحي.




