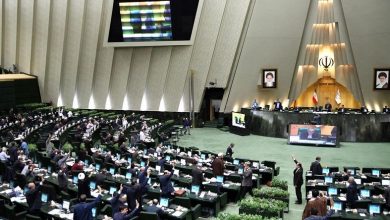“فورين بوليسي” تدق ناقوس الخطر: سلوك الإمارات معيب.. وعلى واشنطن أن تتوقف عن دعمها

حيروت – صحف عالمية
تناولت صحيفة “فورين بوليسي” علاقة الولايات المتحدة بالإمارات، واصفةً سلوك أبو ظبي بالمعيب والمشين.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة، التي أطلق عليها وزير الدفاع الأميركي السابق، جيمس ماتيس، لقب «سبارتا الصغيرة»، في إشارة إلى إمكانيتها العسكرية غير المتناسبة مع حجمها الجغرافي الصغير، على أنها واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ويبدو أن إدارة بايدن تتبنى فعلياً هذا الموقف، إذ وافقت على صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، تشمل طائرات «F-35» إلى أبو ظبي، كانت قد بدأت في عهد إدارة ترامب. كما أشادت بالإمارات العربية المتحدة باعتبارها «شريكاً أمنياً رئيسياً» للولايات المتحدة. وبعد انتخابها أخيراً عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لفترة سنتين اعتباراً في كانون الثاني 2022، يبدو أن «سبارتا الصغيرة» جاهزة الآن لمساعدة الولايات المتحدة في النهوض بمصالحها المشتركة على صعيد أوسع عالمياً.
غير أن هذا النهج مُعيب للغاية. على الرغم من التفاؤل الذي يروّج له أصحاب وجهة النظر هذه، فإن تجاهل سلوك الإمارات العربية المتحدة المشين أضرّ بمصالح الولايات المتحدة، لا في الشرق الأوسط فحسب، إنما في الداخل الأميركي أيضاً.
في الواقع، تساهم سياسات الإمارات في الشرق الأوسط بزعزعة الاستقرار، وتفاقم الحروب الأهلية في المنطقة، وانتهاك القوانين الدولية، والمساهمة في تقويض محاولات إحداث تغييرات ديموقراطية. يضاف إلى هذه المساعي الإقليمية، محاولات الإمارات المتكررة للتدخل في سياسية واشنطن الداخلية على أعلى المستويات، ومراقبة الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم.
بالتالي، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم «للحلفاء»، أثناء مساعيها للخروج من الشرق الأوسط، قبل التركيز على التهديدات الأخرى. ويجب أن تحاسب أولئك الذين يسعون، بشكل غير القانوني، إلى التدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة. ولتحقيق ذلك، لا بد من إيقاف الـ«شيك» على بياض الذي تمنحه للإمارات.
منذ عقود، تسيطر على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ما يشار إليها بـ«أسطورة الاستقرار الاستبدادي». وهذا المصطلح يعني الاعتقاد المعيب بأن المستبدّين في الشرق الأوسط «قادرين على حماية المصالح الأميركية، من خلال فرض النظام السياسي والاجتماعي على المواطنين المستضعفين». إلا أنه، وكما يؤكّد مدير «مركز دراسات الشرق الأوسط» في جامعة دنفر، نادر هاشمي، فإن العكس صحيح. فهذه الأنظمة الاستبدادية «تشكل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار الإقليمي، سواء من حيث طبيعة حكمها، أو السياسات التي انتهجتها».
وتُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة تجسيداً لهذه الأسطورة: فقد عزّز الافتقار إلى المساءلة في الداخل، والدعم المفتوح، أو الـ«شيك» على بياض، من جانب الولايات المتحدة، الإجراءات المزعزعة للاستقرار، والإضرار بمصالح الولايات المتحدة.
ومع امتلاكها لأسلحة أميركية متقدّمة، برزت الإمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من أكثر الدول تدخّلاً في المنطقة، حيث انتهجت سياسات أدّت إلى إطالة أمد الحروب الأهلية، وخلقت أزمات إنسانية، وسحقت المساعي الديموقراطية، وغذّت الممارسات الظالمة التي أدّت إلى انعدام الاستقرار. وفي مصر، كان للإمارات العربية المتحدة دور أساسي في دعم انقلاب عام 2013، الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب ديموقراطياً آنذاك، محمد مرسي، وتنصيب عبد الفتاح السيسي حاكماً، مقدّمةً مساعدة اقتصادية بحجم غير متوقع عقب الانقلاب.
وفي سوريا، كشفت الإمارات عن دعمها للرئيس السوري، بشار الأسد، عبر تأييدها للتدخل العسكري الروسي، في العام 2015، والمشاركة مع موسكو في «عمليات مكافحة الإرهاب»، وإعادة فتح سفارتها في دمشق في العام 2018، وحثّ الجامعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً على إعادة الأسد، الذي أثنت أبو ظبي على «قيادته الحكيمة».
أما في ليبيا، فقدّمت دعماً اقتصادياً وعسكرياً مكثّفاً للجيش الوطني الليبي، بقيادة المارشال الميداني، خليفة حفتر، إذ شنّت ضربات جوية واستخدمت الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تزويد حفتر بالأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. كما اتُّهم الأمراء باستخدام المرتزقة السودانيين لدعم قوات حفتر، وتمويل مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية الذين يقاتلون لصالحه، والمتورّطين في جرائم حرب مزعومة في ليبيا.
وفي اليمن، كانت الإمارات العربية المتحدة طرفاً مباشراً في خلق واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، والتي أودت بحياة أكثر من 230 ألف شخص، ووضعت الملايين على عتبة المجاعة، واستمرارها. هناك، شاركت الإمارات العربية المتحدة في جرائم الحرب، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، وتوجيه حملات الاغتيال باستخدام جنود أميركيين سابقين كمرتزقة. كما أفادت التقارير بأن الأسلحة الأميركية التي تمتلكها الإمارات العربية، نُقلت إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم «القاعدة»، وإلى ميليشيات سلفية متشددة أخرى. وعلى الرغم من أنها ادّعت الانسحاب في العام 2019، فهي مازالت تقدّم الأسلحة والدعم للميليشيات المحلية المضطهِدة، وتستمرّ بالعمليات الجوية الداعمة لهذه الميليشيات، كما لازال تحتل، بشكل غير قانوني، أجزاء من اليمن.
وفي الآونة الأخيرة، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن دعمها للانقلاب في تونس. ومن المرجح أن تكون راضية أيضاً عن الانقلاب في السودان، نظراً إلى علاقاتها القوية مع المؤسسة العسكرية.
كذلك، تساهم ممارسات أبو ظبي الإقليمية والدولية، في الإضرار بسمعة الولايات المتحدة عالمياً. وتجعل وعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، باتّباع سياسة خارجية أميركية تركّز على حقوق الإنسان، نوعاً من النفاق.
وبالإضافة إلى سجلّ الإمارات العربية المتحدة السيئ في حقوق الإنسان داخلياً، ومساهمتها في الأزمات الإنسانية في المنطقة، فقد بررت «اضطهاد الصين لمسلمي الإيغور» فيها ودعمته. وقد استفادت الصين، التي أدانت إدارة باديدن اضطهادها للإيغور باعتباره «إبادة جماعية»، من اعتقال أبوظبي للإيغور المنفيين ونقلهم إلى الصين، بناءً على طلب من بكين. كما أُفيد في آب، بأن أبو ظبي تستضيف منشأة احتجاز سرية، تديرها الصين في دبي، وتهدُف إلى استهداف الإيغور واحتجازهم وترحيلهم.
غير أن المسألة لم تقتصر على الإضرار بمصالح الولايات المتحدة في الخارج، بل سعت أبو ظبي إلى التدخّل المباشر في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، ما يجب أن يُصنّف هجوماً مباشراً على الديموقراطية الأميركية.
في وقت سابق من هذا العام، اتُهم رئيس لجنة تنصيب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، توماس بارك، بالعمل كوكيل أجنبي غير مسجّل، بهدف محاولة التأثير على مواقف إدارة ترامب في السياسة الخارجية. ويدّعي المدّعون العامون في الولايات المتحدة، أن بارك كان موجّهاً من مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، من ضمنهم ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان. وقد دفع بارك بالمرشحين المفضلين لدى أبو ظبي نحو شَغل مناصب على مستوى مجلس الوزراء في الإدارة الجديدة، بما في ذلك مناصب وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف ثلاثة من عملاء المخابرات الأميركية السابقين، في أيلول، بالعمل كجواسيس حاسوبيين للإمارات العربية المتحدة، واختراق شبكات كمبيوتر عدة في الولايات المتحدة. وتعتمد الإمارات منذ فترة طويلة على عملاء سابقين في الاستخبارات الغربية، لمساعدتها في مراقبة دبلوماسيين تابعين للأمم المتحدة، وموظفي الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والمنشقّين السياسيين، ومواطني الولايات المتحدة.
كما يتطرّق تقرير «ميولر»، وهو التقرير الرسمي الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، إلى المسؤولين المرتطبتين بالإمارات العربية المتحدة. وقد ركّز التقرير بشكل محوريّ على واحد منهم، هو جورج نادر، مبعوث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبن زايد، الذي كان على تواصل رفيع المستوى مع مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا والشرق الأوسط.
وتسلّط إحدى الحوادث، التي ذكرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، الضوء على مدى سعي نادر إلى التسلل إلى دائرة ترامب المقرّبة. فوفقاً للصحيفة، وقبيل انتخابات العام 2016، اجتمع ثلاثة أفراد في «برج ترامب»، للقاء دونالد ترامب الإبن، الإبن البكر لترامب المرشّح آنذاك للرئاسة. والأفراد الثلاثة هم نادر، والإسرائيلي الأسترالي المتخصص في التلاعب بوسائل التواصل الإجتماعي، جويل زامل، والرئيس السابق لشركة الأمن الخاصة «بلاك ووتر»، إريك برينس. آنذاك، أبلغ نادر دونالد ترامب الإبن أن «الأمراء الذين يقودون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، متعطّشون لمساعدة والده في الفوز بالانتخابات الرئاسية»، فيما عرض زامل خدمات شركته التي «تخصصت في جمع المعلومات، وتكوين الرأي، من خلال وسائل التواصل الإجتماعي».
وتضيف الصحيفة أن الخطة تضمّنت «استخدام الآلاف من الحسابات المزيّفة على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لترشّح ترامب، على منصات مثل (فيسبوك)». وفي حين يبقى من غير المعروف ما إذا كان قد تمّ تنفيذ الخطة بالفعل، إلا أن «فيسبوك» و«تويتر» اتّهمتا مرات عدة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركة في حملات معقّدة لنشر المعلومات المضللة. ولاحقاً، اتُهم نادر بضخّ الأموال بشكل غير قانوني إلى الحملة الرئاسية، للمرشحة آنذاك، هيلاري كلينتون، في العام 2016.
لقد حان الوقت إذاً لكي تنهي واشنطن دعمها المفتوح لـ«سبارتا الصغيرة»، وتعترف رسمياً بدورها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتقويض التقدم الديموقراطي في المنطقة، وجهودها للتدخل غير القانوني في السياسة الداخلية للولايات المتحدة. والطريقة الأفضل للقيام بذلك، هي إنهاء مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات، المُستخدَمة في إطالة أمد الصراعات الإقليمية، وانتهاك حقوق الإنسان، وانتهاج سياسات لا تصبّ في مصلحة الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الأعمال قد تعرّض مستقبل القاعدة الجوية الأميركية في منطقة الظفرة للخطر، إلا أنه ينبغي اغتنام هذه الفرصة لإعادة النظر في الوجود العسكري الأميركي المكثّف في المنطقة، والذي كان في حدّ ذاته مزعزعاً للاستقرار. ولا بدّ أن تحفّز إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، إعادة النظر في استراتيجية واشنطن الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط أيضاً، والتي تستند إلى «أسطورة الاستقرار الاستبدادي» المُعيبة.