زيارة بايدن للمنطقة.. هل تحصل أم تسبقها التطورات؟ بقلم| حسن نافعة
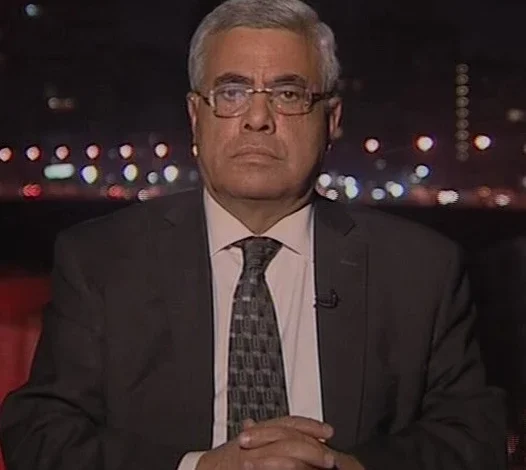
بقلم| حسن نافعة
أخيراً، أعلن رسمياً موعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، وتقرّر أن تجري في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل، وأن تشمل “إسرائيل” والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أنها ستكون في نهاية حزيران/يونيو الحالي، ما يوحي بأن صعوبات عديدة اعترضت ترتيبات الاتفاق على جدولها النهائي، ما تطلّب وقتاً إضافياً للتغلب عليها.
تذكّرنا زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة بزيارة أخرى للسعودية كان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أجراها في أيار/مايو عام 2017. ففي كلتا الزيارتين حرصت المملكة العربية السعودية على دعوة عدد من قادة الدول الأخرى للقاء الرئيس الأميركي على أرضيها. صحيح أن الدعوة إلى لقاء ترامب وجّهت إلى أكثر من أربعين زعيماً، فيما اقتصرت الدعوة إلى لقاء بايدن المرتقب على كل من قادة مصر والعراق والأردن، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن الهدف ظل واحداً في الحالين، وهو تقديم السعودية نفسها زعيمةً على العالمين العربي والإسلامي، لا مجرد دولة خليجية غنية بالنفط والمال، وفيما عدا ذلك تتباين الزيارتان في كل شيء تقريباً، في الأهداف، والبرنامج، وطريقة الإخراج، والسياق الإقليمي والدولي.. فالزيارة التي سيجريها بايدن لن تقتصر على السعودية، مثلما حدث في زيارة ترامب، وإنما ستشمل “إسرئيل” والضفة الغربية أيضاً، والولايات المتحدة التي تحدّث ترامب باسمها عام 2017 ليست هي نفسها التي سيتحدّث بايدن باسمها في تموز/يوليو المقبل، فضلاً عن اختلاف السياق الدولي والإقليمي بين الزيارتين اختلافاً تاماً. ويكفي أن نتذكر هنا أن ترامب بدا حريصاً على أن تكون زيارته للسعودية أول محطة له في برنامج زياراته الخارجية، عقب دخوله البيت الأبيض، لندرك الاهتمام الكبير الذي احتلته تلك الزيارة على جدول أعمال السياسة الخارجية الأميركية وقتذاك، مقارنة بالزيارة المقبلة، التي يبدو أن بايدن سيجريها مضطراً، وعلى مضض!
فقد جاء ترامب عام 2017 حاملاً معه رؤية لما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة الخارجية في عهده، تمحورت حول شعار “أميركا أولاً”، وسعت لتخليص هذه السياسة من أي نكهة قيمية أو أخلاقية أوعاطفية وإعادة رسمها على أسس مصلحية ومادية بحتة. ولأنه لم يكن يرى في السعودية سوى مستودع هائل للنفط، وكنز من الأموال السائلة، فقد بدا ترامب جاهزاً للتعامل معها بمنطق التاجر الباحث عن أفضل الصفقات التي تتيح للاقتصاد الأميركي أن يخرج منها رابحاً إلى أقصى مدى، وتسمح في الوقت نفسه باستقرار أسواق النفط مع الحرص على مصالح “إسرائيل وأمنها” اللذين يعتبرهما جزءاً لا يتجزّأ من مصالحِ الولايات المتحدة وأمنها.
أما ملك السعودية فلم يكن يشغله في ذلك الوقت أكثر من تقديم نجله إلى ترامب باعتباره الشاب المؤهل والأقدر ليس على تولي السلطة في المملكة وحسب، وإنما على قيادة أوسع مشروع تحديث في السعودية والمنطقة. لذا تهيّأت لهذه الزيارة كلّ عناصر النجاح، وقد أسفرت عن إبرام صفقات سياسية وتجارية مربحة للطرفين، ووضع أسس راسخة لعلاقة وثيقة جداً، ومتينة جداً، وشخصية جداً، بين أسرتي ترامب وسلمان. ولم يحصل ترامب لبلاده في الزيارة على مئات مليارات الدولارات من السعودية، على صورة صفقات متنوعة وحسب، إنما بدا بعدها قادراً أيضاً على التحرّك بجرأة في اتجاه نقل مبنى السفارة الأميركية إلى القدس، وضمان عدم اعتراض المملكة على “صفقة القرن” التي كان ينوي طرحها لاحقاً بهدف تصفية القضية الفلسطينية (ما يعني تخلي السعودية فعلياً عن المبادرة العربية، التي طرحها الملك عبد الله في قمة بيروت عام 2002).
أما عاهل السعودية فقد أمكنه وضع نجله محمد في أول طريق التفرّد بحكم المملكة (إذ بعد الزيارة بأسابيع قليلة جرت تنحية محمد بن نايف، وتعيين بن سلمان رسمياً ولياً للعهد)، وحصل على ضوء أخضر لتحجيم قطر، وفرض الحصار عليها (وهو ما جرى أيضاً عقب الزيارة بفترة وجيزة)، ثم أصبح الطريق ممهداً لإطلاق يد ولي العهد الجديد ليس في إدارة سياسة المملكة الداخلية وحسب، ولكن في إدارة سياستها الخارجية أيضاً، وبما يتوافق ودورها الإقليمي والعالمي المطلوب أميركياً. وقد وصلت متانة العلاقات الأميركية السعودية في عهد ترامب إلى حدٍ دفع الأخير إلى تقديم التغطية القانونية والسياسية اللازمة للحيلولة دون توجيه التهمة إلى ولي العهد السعودي في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في مقرِّ القنصلية السعودية في إسطنبول. تجدر الإشارة هنا إلى أننا تعمدنا عدم إدراج قرار ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران عام 2018 ضمن قائمة المكاسب السعودية المتحقّقة من هذه الزيارة، مع أنه صبّ في مصلحتها، لاعتقادنا أنه لم يتّخذ إرضاءً للسعودية وإنما حرصاً على “إسرائيل”.
زيارة بايدن المنتظرة للمنطقة في شهر تموز/يوليو المقبل تأتي في سياق محلي وإقليمي ودولي مختلف تماماً عنه في زيارة ترامب للسعودية عام 2017، خصوصاً أن بايدن كان قد تعهّد إبّان حملته الانتخابية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لم تصبّ في مصلحة السعودية. فقد تعهّد بقصر تعامله الرسمي مع الملك الأب وبعدم وضع يده البتة في يد ولي العهد الملوّثة بدماء خاشقجي، وتعهد كذلك بالعودة إلى الاتفاقية النووية المبرمة مع إيران عام 2015، وبالوقوف ضد انتهاكات حقوق الانسان في العالم..، وكلها تعهّدات أثارت أشد القلق لدى المملكة ودفعتها إلى اتخاذ خطوات للنأي بنفسها بعيداً من الولايات المتحدة والاقتراب أكثر من روسيا والصين. دليلنا على ذلك امتناع السعودية عن توجيه إدانة صريحة ومباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وحرصها على عدم الانخراط النشط في تنفيذ حُزم العقوبات المفروضة على روسيا، وعدم الاستجابة للضغوط الأميركية المتصاعدة لزيادة إنتاجها من النفط، وسعيها لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم مع إيران من خلال مفاوضات مباشرة وغير مباشرة…الخ.
عوامل كثيرة، في مقدّمها تبعات الحرب الدائرة حالياً على الساحة الأوكرانية، أجبرت بايدن على إعادة النظر في معظم مكوّنات سياسته الخارجية المعلنة إبان حملته الانتخابية، خصوصاً ما يتصل منها بعلاقته المحتملة بولي العهد. فحين أعلنت رسمياً، في واشنطن، زيارة بايدن المرتقبة للسعودية، تضمّن برنامج الزيارة لقاء ولي العهد بصورة رسمية!، ما يؤكّد اضطرار بايدن، كشرط للترحيب به ضيفاً في المملكة، إلى تقديم تنازلات مسبقة تقضي بالعدول عن قرار عدم التعامل رسمياً مع محمد بن سلمان، ما يعني الاعتراف به من الآن فصاعداً ليس كولي للعهد وإنما كمرشح لقيادة المملكة العربية السعودية في المستقبل المنظور. لكن، ما الثمن الذي طلبه أو سيطلبه بايدن في المقابل؟
من الواضح أنه طلب فعلاً أو سيطلب أشياء كثيرة، في مقدّمها زيادة إنتاج النفط السعودي بما يكفي لخفض أسعاره عالمياً، والمساعدة النشطة في إحكام الحصار الاقتصادي المفروض على روسيا، وألا تكتفي السعودية بموقف المتفرّج أو حتى المشجّع للدول العربية الأخرى على الانخراط في تطبيع علاقاتها بـ”إسرائيل”، ولكن أن تبادر هي نفسها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه. لكنّ الأخطر من ذلك كله أن بايدن قد يطلب، خصوصاً في ظل الاستعدادات الأميركية الجارية لاحتمال فشل مفاوضات فيينا، وعدم التوصل إلى اتفاق جيد يضمن عودة الولايات المتحدة الى اتفاق البرنامج النووي مع إيران من دون الإضرار بأمن “إسرائيل”، أن تنخرط السعودية في تحالف عسكري يضم “إسرائيل”، إلى جانب دول عربية أخرى، وتقوده الولايات المتحدة في مواجهة إيران. فهل يستجيب ولي العهد لكل هذه المطالب أو لبعضها على الأقل، في مقابل الحصول على مباركة أميركية تضمن له تولي عرش المملكة مستقبلاً؟ وهل يحتاج الأمير حقاً إلى هذه المباركة في ظل انحسار الدور الأميركي في النظام العالمي وتصاعد نفوذ روسيا والصين؟
ربما كان من الأفضل أن ننتظر لنرى أولاً ما إذا كانت زيارة بايدن للمنطقة ستجرى فعلاً أم لا. فالمنطقة والعالم كلّه يمران في حال من السيولة، وعدم اليقين تجعل من الصعب التنبّؤ بما قد يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة، ومنطقة الشرق الأوسط ليست استثناء في هذا العالم. فالحرب الدائرة على الساحة الأوكرانية تتصاعد وتدفع العالم كله نحو حافة مواجهة نووية، ومنطقة الشرق الأوسط تشهد بدورها حالاً من الترقّب والانتظار تجعلها قابلة للانفجار في أي لحظة، ليس بسبب توقّف مفاوضات فيينا واحتمال انهيارها، وإنما لأسباب أخرى كثيرة، منها: الأزمة المستعصية في لبنان، التي ازدادت تعقيداً عقب الانتخابات البرلمانية ومحاولة “إسرائيل” استغلال الوضع للتنقيب عن الغاز في مناطق حدودية متنازع عليها، وانسداد أفق التسوية السياسية للقضية الفلسطينية في ظل اقتحامات إسرائيلية ممنهجة للمسجد الأقصى، وأخيراً تعقّد الوضع السياسي الداخلي في “إسرائيل” واضطرار حكومة “بينيت” إلى طرح مشروع لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ربما تُجرى في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. فهل تؤجّل زيارة بايدن، إلى أن تؤلف حكومة إسرائيلية مستقرة؟
أعتقد أن هذا ليس بالأمر المستحيل حتى ولو بدا مستبعداً عند كتابة هذه السطور. وأياً كان الوضع، فمن المؤكّد أنّ زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة، إن جرت في موعدها المقرر، فستكون في ظل وضع لا تبدو فيه الولايات المتحدة الأميركية في أفضل حال، بل تبدو في وضع الطالب لا المطلوب!




